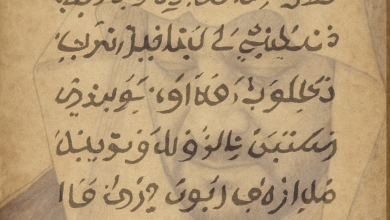بين حماية الصناعة وفقدان الميزة النسبية: التعرفة الجمركية على مسرح الاقتصاد العالمي

بقلم: عبدالرحمن العامري
في خضم تعقيدات الاقتصاد العالمي وتداخل العلاقات التجارية بين الدول، تظهر التعرفة الجمركية كأداة تحمل تناقضات عدة؛ فهي تُستَخدم للدفاع عن الصناعات المحلية وحماية الوظائف، وفي الوقت ذاته قد تفتح الباب للفوضى التجارية وردود الفعل الانتقامية. لم يكن هذا المشهد جديدًا على المسرح الاقتصادي؛ فقد شهد التاريخ العديد من المواقف التي اتسمت بسياسات مماثلة، وغالبًا ما أعادت هذه الإجراءات توزيع وطأة العواقب على الجميع دون تفريق.
ببساطة، تُعدّ التعرفة الجمركية ضريبة تُفرض على السلع المستوردة بهدف رفع تكلفتها مقارنةً بالمنتجات المحلية، لتمكين الصناعات الوطنية من الظهور بقوة في الأسواق المحلية. وفي بعض الأحيان يُنظر إليها كآلية لتخفيف العجز التجاري وتحسين الميزان التجاري للدولة. غير أن هذا التوازن الوهمي غالبًا ما يأتي بثمن باهظ؛ ففي حين تُعزز بعض الصناعات المحلية، ترتفع أسعار السلع المستوردة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
يعود بنا التاريخ إلى عام 1930، في خضم الكساد الكبير، حيث أقرَّت الولايات المتحدة قانون “سموت-هاولي” الذي رفع التعرفة الجمركية على أكثر من 20 ألف سلعة مستوردة في محاولة لحماية الصناعات الوطنية. لكن بدلًا من تحقيق الهدف المنشود، أدت هذه السياسة إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، إذ انهارت التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 66% خلال ثلاث سنوات، مما زاد من وطأة الأزمة الاقتصادية. تُعدّ هذه التجربة درسًا قاسيًا في أن القرارات الاقتصادية المتسرعة قد تتحول إلى مسرحية هزلية مأساوية.
في عام 2018، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتفعيل أداة التعرفة الجمركية كوسيلة سياسية، ففرض تعريفات مرتفعة على واردات عدة دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، مسلطًا الضوء على حماية الوظائف الأمريكية وإعادة توازن الميزان التجاري. لكن التصعيد لم يأتِ بلا ثمن؛ فقد أظهرت الدراسات أن هذه السياسات أدت إلى فقدان حوالي 245,000 وظيفة أمريكية في ذروة التوتر التجاري، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 1.6 تريليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية، بالإضافة إلى انخفاض الصادرات الزراعية إلى الصين بنسبة 50% خلال عام واحد فقط.
أحد العناصر التي غالبًا ما تُغفل في النقاش الاقتصادي هو تأثير مبدأ الميزة النسبية في التجارة الدولية، وهو حجر الزاوية في النظريات التجارية الحديثة التي تُوجب على كل دولة التخصص في إنتاج السلع والخدمات التي تستطيع تقديمها بتكلفة نسبية أقل. إن احترام هذا المبدأ يُعزز من كفاءة التبادل التجاري ويحقق المنافع المتبادلة. ولكن السياسات الحمائية التي تُفرض بأسلوب انفجاري وتجاهل أسس الميزة النسبية تُعيد تشكيل نمط التبادل التجاري بشكل يؤدي إلى اختلال توزيع الموارد وفقدان الكفاءة الإنتاجية، مما يثبط النمو على المدى الطويل.
لم تقتصر التأثيرات على الجانب الأمريكي فحسب، بل تجاوزتها لتطال الاقتصاد العالمي برمته. إذ أدت التوترات الناجمة عن الحرب التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، مع أثر مباشر على الاستثمارات الدولية وتراجع الثقة في الأسواق المالية. هذه التوترات لم تقتصر على مجرد أرقام وإحصاءات، بل انعكست بشكل عملي على حياة ملايين الأشخاص؛ إذ ارتفعت تكلفة السلع المستوردة، مما اضطر الأسرة الأمريكية لدفع مبالغ إضافية تصل إلى حوالي 800 دولار سنويًا وفق بيانات مكتب الميزانية بالكونغرس.
وعلى صعيد الدول ذات العلاقات التجارية الوثيقة مع الولايات المتحدة، تظهر الصورة بوضوح أكبر. المملكة العربية السعودية، التي تُعدّ من الدول الرئيسية في تصدير النفط ومشتقاته والبتروكيماويات، تأثرت بشكل غير مباشر بانخفاض النشاط التجاري العالمي. فقد تذبذب سعر النفط، إذ انخفض من نحو 75 دولارًا للبرميل في منتصف 2018 إلى أقل من 50 دولارًا في بداية 2020، مما تسبب في انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة تجاوزت 25%. ورغم أن السلع السعودية لم تُستهدف مباشرة بتلك التعريفات، فإن حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية أدت إلى تراجع حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 26 مليار دولار عام 2023، مما أثر سلبًا على الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.
وفي خضم هذه المعادلة، ينبثق جانب ساخر يكشف عن واقع الاقتصاد المترابط: كل خطوة سياسية تُتخذ قد تُخلّ بنظام الميزة النسبية الذي يضمن الكفاءة والنمو المتوازن. تبدو السياسات الحمائية كمحاولة لارتداء درع الحماية، إلا أنها تتحول في النهاية إلى دروس مريرة تؤلم معها آثار التضخم وارتفاع الأسعار.
في الختام، يتضح أن الاقتصاد العالمي لا يحتمل الحلول الانفرادية أو التصعيدات التجارية التي تتجاهل الأسس النظرية العميقة مثل الميزة النسبية. ما يحتاجه العالم اليوم هو نهج استراتيجي متوازن وتعاون دولي يؤمن استقرار النمو والتنمية، بدلاً من السياسات الحمائية التي تبدو مغرية على الورق وتنتهي بمسار هزيل يؤدي إلى خسائر تفوق المأمول. الدرس الأهم هنا هو أن حماية الاقتصاد المحلي يجب ألا تأتي على حساب كفاءة النظام العالمي بأكمله؛ فكل خلل بسيط في هذا النظام المترابط يُحدث تأثيرات بعيدة المدى تتجاوز الحدود الوطنية.